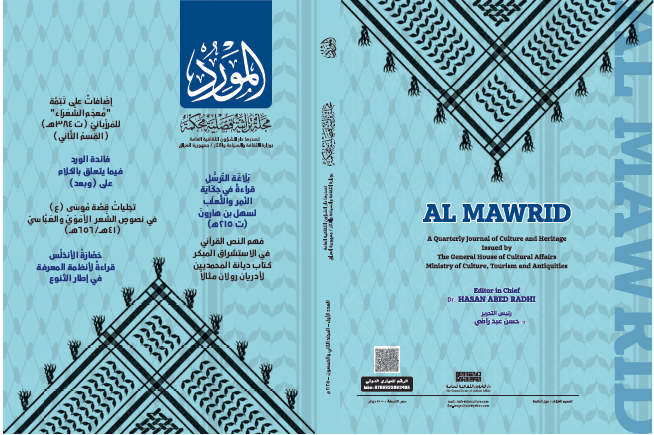Abstract
Among the linguistic phenomena discussed in Al-Shahrastani’s interpretation, and which received significant attention from early scholars, are antonymy and metathesis. Regarding antonymy, scholars were divided into three groups. The first group argued that antonymy and homonymy share a particular-general relationship, as both phenomena involve the union of form (the signifier) while differing in meaning (the signified). However, they differ in that homonyms have distinct meanings, whereas antonyms carry opposite meanings. Since difference is broader than contradiction, they concluded that homonymy is a broader phenomenon than antonymy. Contemporary Arab linguists and researchers have largely adhered to this understanding of antonymy.
The main point of distinction is that the difference between homonymy and antonymy is one of opposition, not mere contrast, as seen in homonymy. However, another group completely denied the existence of antonymy in Arabic, arguing that a single word conveying two opposite meanings creates ambiguity and hinders comprehension. A third group opposed this denial, asserting the validity of antonymy in Arabic. Most linguists believe that defending the phenomenon of antonymy in Arabic is, in part, a defense of its occurrences in the Qur’an.
As for metathesis (spatial transposition), it refers to the reordering of letters within a word—placing one letter before or after another—while generally retaining the word’s original meaning. Any semantic change that occurs is usually minor, as Arabic speakers, by nature, favor linguistic ease and fluidity, often altering phonetic sequences for ease of pronunciation.
Metathesis is considered a type of phonological modification since it alters the original arrangement of letters to align with the linguistic instincts of Arabic speakers. This phenomenon is not unique to Arabic but is also found in other Semitic languages. The following observations can be made:
- Some scholars, such as Ibn Faris, acknowledged the existence of metathesis in linguistic heritage, while others, such as Ibn Durustuyah, denied it.
- It is an auditory phenomenon, meaning that its examples are preserved through usage rather than following a strict grammatical rule.
- Metathesis plays a significant role in morphological structure, as it is one of the most dynamic phonological phenomena, second only to elision. When metathesis occurs in a word, it is often mirrored in its morphological pattern.
- Metathesis serves as a means of linguistic expansion. Every word resulting from metathesis is considered an independent root with full morphological derivations, rather than a mere variant of another form.
- Metathesis does not generally occur with verbs related to sensory perception, except for the verb "ra’ā" (to see) due to its phonetic composition, which includes the hamza (ʾ) and the long alif (ā). This phenomenon appears only in a limited number of Qur’anic occurrences.
- Morphologists have identified conditions and methods for detecting metathesis, helping speakers distinguish between original and metathesized words.
Examples of metathesis cited in Keys to Secrets and Lamps of the Righteous include:
- "safar" (to travel) → "fasar"
- "tarabbasa" (to wait) → "tasabbara" (to endure)
- "kallama" (to speak) → "malaka" (to own)
The main point of distinction is that the difference between homonymy and antonymy is one of opposition, not mere contrast, as seen in homonymy. However, another group completely denied the existence of antonymy in Arabic, arguing that a single word conveying two opposite meanings creates ambiguity and hinders comprehension. A third group opposed this denial, asserting the validity of antonymy in Arabic. Most linguists believe that defending the phenomenon of antonymy in Arabic is, in part, a defense of its occurrences in the Qur’an.
As for metathesis (spatial transposition), it refers to the reordering of letters within a word—placing one letter before or after another—while generally retaining the word’s original meaning. Any semantic change that occurs is usually minor, as Arabic speakers, by nature, favor linguistic ease and fluidity, often altering phonetic sequences for ease of pronunciation.
Metathesis is considered a type of phonological modification since it alters the original arrangement of letters to align with the linguistic instincts of Arabic speakers. This phenomenon is not unique to Arabic but is also found in other Semitic languages. The following observations can be made:
- Some scholars, such as Ibn Faris, acknowledged the existence of metathesis in linguistic heritage, while others, such as Ibn Durustuyah, denied it.
- It is an auditory phenomenon, meaning that its examples are preserved through usage rather than following a strict grammatical rule.
- Metathesis plays a significant role in morphological structure, as it is one of the most dynamic phonological phenomena, second only to elision. When metathesis occurs in a word, it is often mirrored in its morphological pattern.
- Metathesis serves as a means of linguistic expansion. Every word resulting from metathesis is considered an independent root with full morphological derivations, rather than a mere variant of another form.
- Metathesis does not generally occur with verbs related to sensory perception, except for the verb "ra’ā" (to see) due to its phonetic composition, which includes the hamza (ʾ) and the long alif (ā). This phenomenon appears only in a limited number of Qur’anic occurrences.
- Morphologists have identified conditions and methods for detecting metathesis, helping speakers distinguish between original and metathesized words.
Examples of metathesis cited in Keys to Secrets and Lamps of the Righteous include:
- "safar" (to travel) → "fasar"
- "tarabbasa" (to wait) → "tasabbara" (to endure)
- "kallama" (to speak) → "malaka" (to own)
Keywords
Al-Shahraetani
Antonymy
Mafatih al-Asrar
Metathesis
Abstract
من الظواهر اللغوية التي وردت في تفسير الشهرستاني وتناولهما القدماء باهتمام بالغ ، هما ظاهرتا الأضداد، والقلب المكاني، ففي الأضداد اختلفوا الى ثلاث فرق، فريق قال بوجود علاقة الخاص والعام بين التضاد والمشترك اللفظي؛ لأنّ كلتا الظاهرتين اشتركتا في اتحاد اللفظ (الدالّ) وتعدّد المعنى (المدلول)، ويفرّق بينهما أنّ معاني المشترك مختلفة، ومعاني التضاد متناقضة ، والاختلاف أعمّ من التناقض ؛ لذا فإنّ الاشتراك أعمّ من التضادّ. ولم يخرج اللغويون والباحثون العرب المعاصرون عن هذا المفهوم في الأضداد. والحاصل أنَّ الاختلاف بين المشترك اللفظي والتضاد هو اختلاف تضاد وليس اختلاف تغاير كما هو في المشترك. لكنّ طائفةً أخرى منهم أنكرت وقوع التضادّ في العربيّة إنكارا تامّا، وعملوا على تأويل أمثلتها تأويلا يخرجها من هذا الباب؛ وحجّتهم أنّ في دلالة اللفظ الواحد على معنيين مُتضادين بُعداً عن الإبانة والإفهام. وانبرت طائفة ثالثة لكلّ المنكرين لتـردّ عليهم وتُثبت عكس دَعواهم، وأقرّت بإمكان وقوعها . ويُرجع معظم اللغويين الغرض من الدفاع عن ظاهرة التضاد في اللغة العربية هو الدفاع عمّا ورد منها في القرآن الكريم.
أما القلب المكاني فيعني تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ، وذلك بجعل حرف من الكلمة مكان المتقدم عليه أو المتاخر، مع بقاء المعنى فيها واحدا في الغالب ، وإن حدث تغيير في المعنى فإنما يكون طفيفاً ؛ لأنَّ العربي ناطق بفطرته يميل نحو السهولة واليسر في الكلام، فيقدم بعض أصوات الكلمة ويؤخر أخرى . ويعدُّ ضرباً من الإعلال ؛ وذلك لما يعتري بنية الكلمة فيه من تغيير في الوضع الأصلي لبعض حروفها ، من حيث التقديم والتأخير فيها، لصعوبة تتابع الحروف الأصلية على الذوق اللغوي . ويعد القلب المكاني في الكلمة الواحدة ظاهرة مشتركة بين اللغة العربية وبين مثيلاتها من اللغات السامية. ويتبين الآتي :
- أقر بعض العلماء بوجود هذه الظاهرة في التراث اللغوي كابن فارس. ومنهم من أنكرها كابن درستويه . - يكون سماعياً فأمثلته تحفظ ولا يقاس عليها. وإنَّ حدوث هذه الظاهرة في الكلمة يكون من دون قاعدة محددة يسير عليها المتكلم.
- للقلب المكاني أهمية كبيرة في الميزان الصرفي فإنَّه من أكثر الظواهر الصرفية تغيراً في الميزان بعد الإعلال بالحذف فالقلب المكاني الذي يحدث في الكلمة يقابله حدوث قلب مكاني في الميزان.
- إنَّ القلب المكاني لم يؤتَ به إلا للتوسع في اللغة، فكل كلمة تنتج من القلب المكاني تعد أصلاً كامل التصاريف، فلا يكون هناك أصلٌ وفرع.
- لم يرد القلب المكاني مع أفعال الحواس إلا مع الفعل (رأى) وذلك لاحتوائه على الهمزة والألف. ولم يرد في القرآن الكريم مع هذا الفعل إلا في مواضع معدودة .
- ذكر علماء الصرف شروطا لمعرفة القلب المكاني ، ووسائل تساعد المتكلم على معرفة الكلمة الأصلية، وتميزها عن الكلمة التي حصل فيها قلب .
- وقد ورد في كتاب ( مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار) أمثلة للقلب المكاني ، ومنها: ( فَسَرَ – سَفَرَ ) و( تَرَبَّصَ – تَصَبَّرَ) و( كلم – ملك)
أما القلب المكاني فيعني تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ، وذلك بجعل حرف من الكلمة مكان المتقدم عليه أو المتاخر، مع بقاء المعنى فيها واحدا في الغالب ، وإن حدث تغيير في المعنى فإنما يكون طفيفاً ؛ لأنَّ العربي ناطق بفطرته يميل نحو السهولة واليسر في الكلام، فيقدم بعض أصوات الكلمة ويؤخر أخرى . ويعدُّ ضرباً من الإعلال ؛ وذلك لما يعتري بنية الكلمة فيه من تغيير في الوضع الأصلي لبعض حروفها ، من حيث التقديم والتأخير فيها، لصعوبة تتابع الحروف الأصلية على الذوق اللغوي . ويعد القلب المكاني في الكلمة الواحدة ظاهرة مشتركة بين اللغة العربية وبين مثيلاتها من اللغات السامية. ويتبين الآتي :
- أقر بعض العلماء بوجود هذه الظاهرة في التراث اللغوي كابن فارس. ومنهم من أنكرها كابن درستويه . - يكون سماعياً فأمثلته تحفظ ولا يقاس عليها. وإنَّ حدوث هذه الظاهرة في الكلمة يكون من دون قاعدة محددة يسير عليها المتكلم.
- للقلب المكاني أهمية كبيرة في الميزان الصرفي فإنَّه من أكثر الظواهر الصرفية تغيراً في الميزان بعد الإعلال بالحذف فالقلب المكاني الذي يحدث في الكلمة يقابله حدوث قلب مكاني في الميزان.
- إنَّ القلب المكاني لم يؤتَ به إلا للتوسع في اللغة، فكل كلمة تنتج من القلب المكاني تعد أصلاً كامل التصاريف، فلا يكون هناك أصلٌ وفرع.
- لم يرد القلب المكاني مع أفعال الحواس إلا مع الفعل (رأى) وذلك لاحتوائه على الهمزة والألف. ولم يرد في القرآن الكريم مع هذا الفعل إلا في مواضع معدودة .
- ذكر علماء الصرف شروطا لمعرفة القلب المكاني ، ووسائل تساعد المتكلم على معرفة الكلمة الأصلية، وتميزها عن الكلمة التي حصل فيها قلب .
- وقد ورد في كتاب ( مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار) أمثلة للقلب المكاني ، ومنها: ( فَسَرَ – سَفَرَ ) و( تَرَبَّصَ – تَصَبَّرَ) و( كلم – ملك)
Keywords
الأضداد، القلب المكاني، الشهرستاني، مفاتيح الأسرار